السيادة والمواطنة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
 السيادة والمواطنة
السيادة والمواطنة
يعتقد عامة الناس أن المواطنة تتلخص في الحضور المادي في بلد ما أو أنها تتلخص في مجموعة من الحقوق التي لا يقابلها أي التزام. وهذا الاعتقاد خاطئ لسببين أوّلا لأنه يقوم ضمنيا على خلط بين المواطن والمواطنة. وثانيا لأنه يخلط بين المواطنة وأصناف الانتماء الأخرى سواء كانت ثقافية أو دينية أو إيديولوجية أو اجتماعية في حين أن فهم المواطنة يقتضي تحديدها في علاقاتها بالسيادة السياسية وبالديمقراطية وهو ما تفطّن إليه أرسطو عندما أقرّ "المواطن كما حدّدناه هو على الخصوص مواطن الديمقراطية" والديمقراطية ليست شيئا آخر عدا سيادة الشعب للشعب، وهذا يعني أن المواطن هو عنصر فاعل في الحياة العامة، عنصر فاعل في المدينة، ذلك أن كلمة مواطن الفرنسية Citoyen مشتقة من كلمة Civitas اللاتينية والتي تعني المدنية أو الجمهورية وبالتالي الدولة، عنصر فاعل في المدينة يعني إذن عنصر فاعل في الاجتماع السياسي وبالتالي في الدولة التي يكونها الشعب الذي يمارس السيادة على نفسه.
وفي النظام الديمقراطي المواطن هو من يشارك في السيادة الشعبية، فيمارس حقّ الانتخاب ويختار التوجهات العامة في تدبير شؤون الحياة السياسية، هذا الترابط بين المواطنة والديمقراطية جعل "جون جاك روسّو" يقرّ بأنه "حالما يوجب سيّد لا وجود بعد لشعب يتصف بالسيادة" فلا يمكن الحديث إذن عن مواطنة في إطار حكم استبدادي وبالنسبة لروسّو تسمح الارادة العامة بالمصالحة بين الحرية الفردية والسيادة الجماعية ذلك أنّ كلّ فرد يتعاقد مع كامل الجسم السياسي، وكلّ فرد هو صاحب سيادة وبالتالي يشارك في سيادة الدولة من جهة كونه مشرع مشارك في الحياة العامة ورعية في ذات الوقت من جهة كونه خاضع لقوانين الدولة التي شارك في تشريعها، وهو ما يتحقق في الدولة الديمقراطية.
المواطن مسؤول إذن عن الحياة المدنية، فهو من يمارس المواطنة التي تتحدّد في هذا المنظور باعتبارها علاقة ولاء للسلطة السياسية وحماية للمواطن من هذه السلطة بما في ذلك الحماية الدبلوماسية للمواطن في غير وطنه. فالمواطنة هي المشاركة في الحياة السياسية، هي ممارسة وضمان للحقوق المدنية والسياسية، والمواطن هو فردٌ ينخرط في سلطة الدولة وفي حمايتها، وبالتالي يتمتع بحقوق مدنية ويقوم بواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إليها. وفكرة الانتماء هذه تحيل إلى كون المواطنة ترتبط عموما بهوية وطنية خاصة، وبالتالي ترتبط المواطنة بالتحيّز الإقليمي والتاريخي الذي يعين متغيرات انتماء الأفراد. وفكرة الانتماء هذه تمثل مصدر خلط عامة الناس بين المواطنة والحضور المادي في بلد ما في حين أنّ المواطنة تتجاوز محدود الحضور المادي مثلما أقر ذلك "أرسطو" في قوله : "لا يكون المرء مواطنا بمحلّ الإقامة وحده".
كما أنّ فكرة الانتماء تربط المواطنة بثقافة وطنية تغذيها الذاكرة الشعبية. وهذا الرابط بين المواطنة والثقافة الوطنية يمثل مصدر الخطأ الثاني الذي يخلط بين المواطنة وأصناف الانتماءات الأخرى، خاصة وأنّ هذا الخلط يفتح على مخاطر قد تؤدي إلى الاستبداد السياسي، بما أنّ هذا الخلط يقضي على التنوع والاختلاف الخلاق. وهذا يعني أن المواطن بقطع النظر عن انتماءه الثقافي أو الديني أو الاجتماعي أو الأيديولوجي يمارس، وبطريقته الخاصة، المواطنة كما تحدّدها قوانين الدولة التي ينتمي لها، ومن هنا بالذات تتولّد ضرورة التمييز بين المواطن والمواطنة.
وهكذا يمكن أن نستخلص مما تتقدم أن المواطنة تتحدد في ثلاث مستويات:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->المستوى الأوّل تتحدّد فيها المواطنة باعتبارها مثالي "Ideal" بمعني قيم محفزة.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->وتتحدّد في مستوى ثاني باعتبارها مجموعة متمفصلة من المعايير السياسية والحقوقية، أي مجموعة من الحقوق والواجبات التي تضفي الواحدة منها الشرعية على الأخرى وتسهر السلطة السياسية على رعايتها بطريقة ما.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->وهي في مستوى ثالث مجموعة الممارسات الفعلية التي يقوم بها المواطنون ليشاركوا بطريقة فعالة في تنشيط الحياة الجماعية في إطار الدولة.
وباعتبارها قيم ومعايير وسلوكات اجتماعية فعلية لا يمكن القول بأنّ المواطنة طبيعية بل هي عنصر ثقافي يـُبنى تاريخيا وبالتالي مكسب يُمرّر كي يتواصل ويتطوّر، ولذلك ترتبط المواطنة بالديمقراطية وبالتالي بالسيادة.
غير أنّ ارتباط المواطنة بالسيادة يجعلها على كفّ عفريت إذ تكون وضعيتها حرجة للغاية ويمكن أن يفقدها الفرد كلما عمد إلى نسيان طبيعتها أو كلّما فسدت الديمقراطية فالسيادة عند "روسو" كما هو الحال عند "منتسكيو" غير قابلة للقسمة ثم هي مطلقة بما أنها فوق القانون، إذ هي التي ترسي القانون، والخطر يتأتى من ربط السيادة بالدولة إذ قد تتماهى السيادة مع الدولة مثلما هو شأن الخلط بين الدولة والمجتمع المدني وهو خلط حذّر منه "هيغل" عندما نقد نظرية العقد الاجتماعي، فالخلط بين السيادة والدولة والمجتمع المدني والدولة يؤدّي إلى ما سمّاه "سان سيمون" بدولنة المجتمع l’Etatisation de la societe أي سيطرة الدولة على كلّ هياكل ومؤسسات المجتمع المدني فنسقط في نوع جديد من الاستبداد السياسي، ولكن نوع خطير بما أنه استبداد باسم الديمقراطية سمّاه "توكفيل" بالاستبداد الناعم. ثم إنّ المماهاة بين السيادة والدولة قد تؤدّي إلى تصوّرات تجزّئ السيادة مثلما هو الشأن مع "غروتيوس" الذي يحدّد السيادة باعتبارها مجموعة مهام يمارسها صاحب السيادة مثل سلطة "صكّ العملة"، سلطة إقامة العدالة... وكلّ المهام التي تقوم بها الدولة والتي تسمى في السجلّ السياسي الحقوقي المهامّ الملكية التي تؤسّس قوة الدولة والتي يمكن التفريط فيها، والسيادة بهذا المعنى تكون قابلة للقسمة ولذلك كان "روسّو" قد انتقد تصوّر "غروتيوس" للسيادة وأقرّ بكون السيادة كاملة وغير قابلة للقسمة. ذلك أنّ السيادة في معناها الدقيق هي السلطة العليا، و الذي يمارس هذه السيادة ليس له سلطة فوقه، فمهامه لا ترتبط بأي سلطة أعلى منه، وهو ما يتضمن كون صاحب السيادة حر بصفة كاملة و مستقل.
وهذه الاستقلالية و الحرية للسيادة تتمظهر في مستوى الحق التأسيسي في الدول الديمقراطية، فالشعب حر في أن يشرع القوانين التي يريد، وحر في أن يراجع الدستور متى شاء، بل و حر حتى في تجاوز الدستور حسب بعض الحقوقيين. كما تتمظهر هذه الاستقلالية في مستوى القانون الدولي فكل شعب حر في تقرير مصيره و يتمتع بمساواة حقوقية مع بقية الشعوب. ذلك انه إن كانت سلطة السيادة عليا فإنها بالضرورة غير قابلة للقسمة وهي حق غير قابل للتصرف إذ لا تستطيع أن تكون عليا و أن تتنازل عن جزء من سلطتها لفائدة أي جهة أخرى في نفس الوقت. و من هذا المنطلق يميّز المنظرون الثوريون في الحق التأسيس بين السلطة العليا ( السيادة) و أجهزة الدولة. فبالنسبة لـ"روسو"، الدولة لا تمثل صاحب السيادة الفعلي فصاحب السيادة هو الشعب الذي لا يقاسم و لا يفوّت في إرادته، يقول روسو «إن السيادة التي ليست سوى ممارسة الإرادة العامة لا يمكن أبدا أن تكون محل تنازل». أمّا الدولة فهي من يعطي القوة الفعلية لهذه الإرادة، ذلك أنّ روسو يعتبر أن الشعب هو صاحب السيادة من جهة كونه يمثل الإرادة العامة، و سلطات الدولة ليست إلا تعبيرات عن هذه الإرادة فالدولة لا تتكلم و لا تفعل إلا باسم الشعب و بالتالي تجد الدولة دائما حدا داخليا لفعلها. و إذا كانت السيادة غير قابلة للقسمة أو التصرّف فيها، فإننا لا نستطيع أن نقول نفس الشيء عن سلطة الدولة التي يمكن أن تقسم و يمكن أن يفوت فيها جزئيا, لذلك فإن كل خلط بين السيادة و سلطة الدولة يؤدي إلى النظم الكليانية و بالتالي تهديد المواطنة بما أن المواطنة لا تتحقق إلا في النظام الديمقراطي، لكن النظام الديمقراطي السليم الذي يسعى إلى تحقيق العدالة و المساواة.
و يجب أن نلاحظ أنه ثمة اليوم عدو آخر يترصد بالمواطنة و السيادة معا،إنه هيمنة الاقتصاد و السوق الكوني على السياسي، هيمنة تتجلى في العولمة كادعاء للكونية. وأول تداعيات العولمة على المواطنة تتمثل في تحويل المواطن إلى مستهلك في سيرورة تحويل وجهة عندما لا يتعلق الأمر بتحويل مقصود و معلن. و هذه العملية تنخرط في نزعة قوية تتمثل في الحط من شأن السياسة في مقابل إرادة الرفع من شأن السوق باعتباره المجال الكوني لسيادة المواطن. و هكذا تنحط المواطنة إلى ابخس تعبيرة عنها، و تتوقف حرية الاختيار لدى المواطن عند أنواع الاستهلاكيات في السوق, أما صناديق الاقتراع و بطاقات الانتخاب فتبدو في إيديولوجيا السوق تخلفا. و هذا الانزياح في معنى المواطنة الذي لا يكاد يرى, إذ يمرر باسم الديمقراطية ذاتها، يطرح مشكلا خطيرا على الإنساني، مشكل سلب عدد متزايد من الأفراد من مشاركتهم في السيادة، خاصة و أن الخيار الاستهلاكي لا يمثل خيارا عقلانيا بالنسبة للمصلحة العامة، لان المصلحة العامة لا تختزل في مجموع المصالح الخاصة بكل فرد، وهو بالذات ما تروج له الفردانية في النظم الديمقراطية المعاصرة حسب "توكفيل". و هكذا فإن الأفراد الذين ليس لهم الإمكانات المادية التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع الاستهلاكي يجدون أنفسهم مستبعدين و محرومين من حق التعبير في الحقل العام مثلما عبر عن ذلك "هابرماس", والمواطنة التي كانت تمكن من تجاوز اللاعدالة في مختلف أصنافها و مختلف أبعاد الوجود الإنساني و التي كانت تمكن كل فرد من حق مساو في ممارسة السيادة الشعبية تركت مكانها للاستهلاك, و يبدو أن مجتمع السوق يعيد اليوم تأسيس نوع من حق الانتخاب الضرائبي في واقع تفشي الفساد السياسي في الديمقراطيات المعاصرة.
و بما أن السوق لا يمكنه أن يعوض المنتدى الشعبي, إذ هو لا يمثل المجال الذي يستطيع كل فرد أن يمارس فيه اختيارا عقلانيا فإن الفرد المستهلك لا يمكن أن تكون له في السوق سلطة ديمقراطية، وتحوّل المواطن إلى مستهلك يعني نهائيا التخلي عن الديمقراطية الاجتماعية وظهور نوع جديد من النظام يسميه بعض المفكرين بالديمقراطية الشعبوية للسوق، نظام تختزل فيه السيادة الشعبية في علاقة تاجر ومستهلك. وهذا الواقع الذي شخصه "توكيفيل" في ما سمّاه بالاستبداد الناعم والذي حلله "أدورنو" و"هوركايمر" جعل "ماركوز" ينتهي إلى رؤية تشاؤمية في نقده للمجتمع الاستهلاكي ذلك أن مجتمع السوق المحكوم بأوامر ماركانتيلية خاصة، اوامر اقتصاد السوق، لا يؤسس العدالة الاجتماعية، خاصة وأن هذه الأوامر ليس لها ما يحدّها أو ما يعارضها في الوقت الراهن عدى بعض حركات المقاومة الشعبية المعزولة والتي تأخذ شكل مظاهر عنيفة أو مرضية وحتى لا عقلانية في منظور العولمة مثلما بين ذلك "بودريار" الذي يبدو أكثر تفاؤلا من "ماركور" بما أنه، على الأقل، يعتبر أن العولمة لا تستطيع أن تعلن نصرها طالما هناك مقاومة.
غير أن الوضعية القانونية للمقامة تطرح مشكلا حقوقيا من وجهة نظر كانط، ذلك أنه "ليس ثمة أي مقاومة للشعب ضدّ الحاكم المشرع للدولة تكون مطابقة للحق"، فليس ثمة "حق عصيان" ولا "حق تمرّد". وكانط يذهب إلى أبعد من ذلك إذ يعتبر أن "أبسط محاولة في هذا الشأن هي خيانة عُظمى ومن يكون خائنا من هذا الجنس، باحثا على القضاء على وطنه لا يمكن أن يُعاقب بأقل من الموت". و في هذا الاقرار يبدو كانط وكأنه يتكلم على لسان أباطرة السوق، أولئك الذين ينعتون بالإرهاب كلّ محاولة للتصدّي لنجاحات اقتصاد السوق المعولم، وربما ما يبرّر هذا التحامل الكانطي على المقاومة، هو كون المشروع الكانطي يندرج في إطار بحثه عن تحقيق سلم دائم، وشأن كانط كفيلسوف هو أن يتحرّك وفق خلفية أخلاقية تجعله يرفض العنف في كلّ أشكاله حتى وإن كان مقاومة للطغيان، وكأن بكانط يسير على خطى "سقراط" عندما عرضوا عليه الفرار من السجن قبل إعدامه فرفض لأنه من واجبه احترام قوانين المدينة حتى وإن كانت جائرة. ولكن الفلسفة التي يمثل الاختلاف شأنها الملكي، جعلت ماركس يعتبر أن العنف الثوري الذي تمارسه الطبقة الكادحة هو عنف شرعي. فعندما يجعل الاستبداد بعنفه محلّ الحق والعدالة يجب مقاومته، فالاستبداد عنف ومقاومة هذا العنف لا تكون بالنسبة لماركس بالخطاب فحسب بل وأيضا بالقوة خاصة وأنها تبقى دينامية يمكن التحكم فيها في مقابل العنف الذي يمثل دينامية مجنونة.
ورغم إدانة كانط للمقامة، فإنه ليس لنا أن ننسى إضافته في مستوى دعوته للكونية، إذ مكننا كانط من الربط بين مستويات المواطنة، بين مواطن الدولة والمواطن العالمي بطريقة تسمحُ بالمصالحة بين الحق وكرامة الإنسان، بين هوية وسيادة الشعوب وتآزر كلّ متساكني الكوكب بما في ذلك اللاجئين السياسيين الذين حرموا من حق حماية دولة خاصة. ذلك أن المواطنة العالمية عند "كانط" تقتضي الاعتراف بالآخر كآخر، فالآخر في هذا المنظور الكانطي ليس غريبا بصفة مطلقة وليس هو نسخة مطابقة للذات، والعالمية التي ينادي بها "كانط" تصالح بين خصوصية الشعوب والغيرية، تصالح بين الهوية والاختلاف، تبرز الكوني في الخصوصي والخصوصي في الكوني. ذلك هو شرط الحوار الأصيل الذي يمكننا من تجاوز المفارقة التي أحالت إليها "حنّا أرانت" بين الحقوق الكونية والتجمّعات الخصوصية، حسبنا فقط أن ننتبه إلى الاستبداد الناعم الذي شخصه "توكيفيل" والذي هو بصدد بسط سلطانه بخطى حثيثة في الديمقراطيات المعاصرة. ولكن علينا أيضا أن نحترس من العولمة والفضاءات الجديدة التي أنتجتها لتفعل فيما بعد الحدود الجغرافية وما قد تمثله من خطر على السيادة وبالتالي على المواطنة التي لا تتحقق إلا في ظلّ الديمقراطية، فالمواطنة تتكون عبر الحوار وتبادل الأفكار وهو ما يقتضي تفكيرا مناسبا حول دور الاعلام في المدينة، خاصة وأن الاعلام اليوم يتموضع في مشهد السوق ولا يهتم أبدا بتبادل الأفكار وإنما يهتمّ بخطابات الأوغاد والحمقى مثلما عبر عن ذلك "ميشال هنري" في كتابه "البربرية"، ثم إن دكتاتورية وسائل الاتصال تمنع كلّ نقد باسم حرية الصحافة. ونخشى اليوم من أن تهيمن الديمقراطية الاتصالية وأن تهيمن وسائل الاعلام فتغيب الديمقراطية، لذلك يجب استغلال العولمة لنعلن الواجب الملح اليوم، واجب رفعه "كانط" منذ الحداثة يتمثل في بناء مواطنة عالمية تتأسّس على الثلاثية: حرية، مساواة، وإخاء، لأنه أن يكون الواحد منا مواطنا عالميا هو أن يعرف وأن يفهم وأن يشارك في حوارات المدينة الذي تمثلها اليوم "القرية العالمية" واللاّتجانس ليس حاجزا وإنما هو مثلما بيّن ذلك "إدغار موران" عامل محرّر : "إنه يجعل الامبراطوريات القديمة والحديثة تنهار ويفضل التجارب والوضعيات الجديدة".
وفي النظام الديمقراطي المواطن هو من يشارك في السيادة الشعبية، فيمارس حقّ الانتخاب ويختار التوجهات العامة في تدبير شؤون الحياة السياسية، هذا الترابط بين المواطنة والديمقراطية جعل "جون جاك روسّو" يقرّ بأنه "حالما يوجب سيّد لا وجود بعد لشعب يتصف بالسيادة" فلا يمكن الحديث إذن عن مواطنة في إطار حكم استبدادي وبالنسبة لروسّو تسمح الارادة العامة بالمصالحة بين الحرية الفردية والسيادة الجماعية ذلك أنّ كلّ فرد يتعاقد مع كامل الجسم السياسي، وكلّ فرد هو صاحب سيادة وبالتالي يشارك في سيادة الدولة من جهة كونه مشرع مشارك في الحياة العامة ورعية في ذات الوقت من جهة كونه خاضع لقوانين الدولة التي شارك في تشريعها، وهو ما يتحقق في الدولة الديمقراطية.
المواطن مسؤول إذن عن الحياة المدنية، فهو من يمارس المواطنة التي تتحدّد في هذا المنظور باعتبارها علاقة ولاء للسلطة السياسية وحماية للمواطن من هذه السلطة بما في ذلك الحماية الدبلوماسية للمواطن في غير وطنه. فالمواطنة هي المشاركة في الحياة السياسية، هي ممارسة وضمان للحقوق المدنية والسياسية، والمواطن هو فردٌ ينخرط في سلطة الدولة وفي حمايتها، وبالتالي يتمتع بحقوق مدنية ويقوم بواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إليها. وفكرة الانتماء هذه تحيل إلى كون المواطنة ترتبط عموما بهوية وطنية خاصة، وبالتالي ترتبط المواطنة بالتحيّز الإقليمي والتاريخي الذي يعين متغيرات انتماء الأفراد. وفكرة الانتماء هذه تمثل مصدر خلط عامة الناس بين المواطنة والحضور المادي في بلد ما في حين أنّ المواطنة تتجاوز محدود الحضور المادي مثلما أقر ذلك "أرسطو" في قوله : "لا يكون المرء مواطنا بمحلّ الإقامة وحده".
كما أنّ فكرة الانتماء تربط المواطنة بثقافة وطنية تغذيها الذاكرة الشعبية. وهذا الرابط بين المواطنة والثقافة الوطنية يمثل مصدر الخطأ الثاني الذي يخلط بين المواطنة وأصناف الانتماءات الأخرى، خاصة وأنّ هذا الخلط يفتح على مخاطر قد تؤدي إلى الاستبداد السياسي، بما أنّ هذا الخلط يقضي على التنوع والاختلاف الخلاق. وهذا يعني أن المواطن بقطع النظر عن انتماءه الثقافي أو الديني أو الاجتماعي أو الأيديولوجي يمارس، وبطريقته الخاصة، المواطنة كما تحدّدها قوانين الدولة التي ينتمي لها، ومن هنا بالذات تتولّد ضرورة التمييز بين المواطن والمواطنة.
وهكذا يمكن أن نستخلص مما تتقدم أن المواطنة تتحدد في ثلاث مستويات:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->المستوى الأوّل تتحدّد فيها المواطنة باعتبارها مثالي "Ideal" بمعني قيم محفزة.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->وتتحدّد في مستوى ثاني باعتبارها مجموعة متمفصلة من المعايير السياسية والحقوقية، أي مجموعة من الحقوق والواجبات التي تضفي الواحدة منها الشرعية على الأخرى وتسهر السلطة السياسية على رعايتها بطريقة ما.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->وهي في مستوى ثالث مجموعة الممارسات الفعلية التي يقوم بها المواطنون ليشاركوا بطريقة فعالة في تنشيط الحياة الجماعية في إطار الدولة.
وباعتبارها قيم ومعايير وسلوكات اجتماعية فعلية لا يمكن القول بأنّ المواطنة طبيعية بل هي عنصر ثقافي يـُبنى تاريخيا وبالتالي مكسب يُمرّر كي يتواصل ويتطوّر، ولذلك ترتبط المواطنة بالديمقراطية وبالتالي بالسيادة.
غير أنّ ارتباط المواطنة بالسيادة يجعلها على كفّ عفريت إذ تكون وضعيتها حرجة للغاية ويمكن أن يفقدها الفرد كلما عمد إلى نسيان طبيعتها أو كلّما فسدت الديمقراطية فالسيادة عند "روسو" كما هو الحال عند "منتسكيو" غير قابلة للقسمة ثم هي مطلقة بما أنها فوق القانون، إذ هي التي ترسي القانون، والخطر يتأتى من ربط السيادة بالدولة إذ قد تتماهى السيادة مع الدولة مثلما هو شأن الخلط بين الدولة والمجتمع المدني وهو خلط حذّر منه "هيغل" عندما نقد نظرية العقد الاجتماعي، فالخلط بين السيادة والدولة والمجتمع المدني والدولة يؤدّي إلى ما سمّاه "سان سيمون" بدولنة المجتمع l’Etatisation de la societe أي سيطرة الدولة على كلّ هياكل ومؤسسات المجتمع المدني فنسقط في نوع جديد من الاستبداد السياسي، ولكن نوع خطير بما أنه استبداد باسم الديمقراطية سمّاه "توكفيل" بالاستبداد الناعم. ثم إنّ المماهاة بين السيادة والدولة قد تؤدّي إلى تصوّرات تجزّئ السيادة مثلما هو الشأن مع "غروتيوس" الذي يحدّد السيادة باعتبارها مجموعة مهام يمارسها صاحب السيادة مثل سلطة "صكّ العملة"، سلطة إقامة العدالة... وكلّ المهام التي تقوم بها الدولة والتي تسمى في السجلّ السياسي الحقوقي المهامّ الملكية التي تؤسّس قوة الدولة والتي يمكن التفريط فيها، والسيادة بهذا المعنى تكون قابلة للقسمة ولذلك كان "روسّو" قد انتقد تصوّر "غروتيوس" للسيادة وأقرّ بكون السيادة كاملة وغير قابلة للقسمة. ذلك أنّ السيادة في معناها الدقيق هي السلطة العليا، و الذي يمارس هذه السيادة ليس له سلطة فوقه، فمهامه لا ترتبط بأي سلطة أعلى منه، وهو ما يتضمن كون صاحب السيادة حر بصفة كاملة و مستقل.
وهذه الاستقلالية و الحرية للسيادة تتمظهر في مستوى الحق التأسيسي في الدول الديمقراطية، فالشعب حر في أن يشرع القوانين التي يريد، وحر في أن يراجع الدستور متى شاء، بل و حر حتى في تجاوز الدستور حسب بعض الحقوقيين. كما تتمظهر هذه الاستقلالية في مستوى القانون الدولي فكل شعب حر في تقرير مصيره و يتمتع بمساواة حقوقية مع بقية الشعوب. ذلك انه إن كانت سلطة السيادة عليا فإنها بالضرورة غير قابلة للقسمة وهي حق غير قابل للتصرف إذ لا تستطيع أن تكون عليا و أن تتنازل عن جزء من سلطتها لفائدة أي جهة أخرى في نفس الوقت. و من هذا المنطلق يميّز المنظرون الثوريون في الحق التأسيس بين السلطة العليا ( السيادة) و أجهزة الدولة. فبالنسبة لـ"روسو"، الدولة لا تمثل صاحب السيادة الفعلي فصاحب السيادة هو الشعب الذي لا يقاسم و لا يفوّت في إرادته، يقول روسو «إن السيادة التي ليست سوى ممارسة الإرادة العامة لا يمكن أبدا أن تكون محل تنازل». أمّا الدولة فهي من يعطي القوة الفعلية لهذه الإرادة، ذلك أنّ روسو يعتبر أن الشعب هو صاحب السيادة من جهة كونه يمثل الإرادة العامة، و سلطات الدولة ليست إلا تعبيرات عن هذه الإرادة فالدولة لا تتكلم و لا تفعل إلا باسم الشعب و بالتالي تجد الدولة دائما حدا داخليا لفعلها. و إذا كانت السيادة غير قابلة للقسمة أو التصرّف فيها، فإننا لا نستطيع أن نقول نفس الشيء عن سلطة الدولة التي يمكن أن تقسم و يمكن أن يفوت فيها جزئيا, لذلك فإن كل خلط بين السيادة و سلطة الدولة يؤدي إلى النظم الكليانية و بالتالي تهديد المواطنة بما أن المواطنة لا تتحقق إلا في النظام الديمقراطي، لكن النظام الديمقراطي السليم الذي يسعى إلى تحقيق العدالة و المساواة.
و يجب أن نلاحظ أنه ثمة اليوم عدو آخر يترصد بالمواطنة و السيادة معا،إنه هيمنة الاقتصاد و السوق الكوني على السياسي، هيمنة تتجلى في العولمة كادعاء للكونية. وأول تداعيات العولمة على المواطنة تتمثل في تحويل المواطن إلى مستهلك في سيرورة تحويل وجهة عندما لا يتعلق الأمر بتحويل مقصود و معلن. و هذه العملية تنخرط في نزعة قوية تتمثل في الحط من شأن السياسة في مقابل إرادة الرفع من شأن السوق باعتباره المجال الكوني لسيادة المواطن. و هكذا تنحط المواطنة إلى ابخس تعبيرة عنها، و تتوقف حرية الاختيار لدى المواطن عند أنواع الاستهلاكيات في السوق, أما صناديق الاقتراع و بطاقات الانتخاب فتبدو في إيديولوجيا السوق تخلفا. و هذا الانزياح في معنى المواطنة الذي لا يكاد يرى, إذ يمرر باسم الديمقراطية ذاتها، يطرح مشكلا خطيرا على الإنساني، مشكل سلب عدد متزايد من الأفراد من مشاركتهم في السيادة، خاصة و أن الخيار الاستهلاكي لا يمثل خيارا عقلانيا بالنسبة للمصلحة العامة، لان المصلحة العامة لا تختزل في مجموع المصالح الخاصة بكل فرد، وهو بالذات ما تروج له الفردانية في النظم الديمقراطية المعاصرة حسب "توكفيل". و هكذا فإن الأفراد الذين ليس لهم الإمكانات المادية التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع الاستهلاكي يجدون أنفسهم مستبعدين و محرومين من حق التعبير في الحقل العام مثلما عبر عن ذلك "هابرماس", والمواطنة التي كانت تمكن من تجاوز اللاعدالة في مختلف أصنافها و مختلف أبعاد الوجود الإنساني و التي كانت تمكن كل فرد من حق مساو في ممارسة السيادة الشعبية تركت مكانها للاستهلاك, و يبدو أن مجتمع السوق يعيد اليوم تأسيس نوع من حق الانتخاب الضرائبي في واقع تفشي الفساد السياسي في الديمقراطيات المعاصرة.
و بما أن السوق لا يمكنه أن يعوض المنتدى الشعبي, إذ هو لا يمثل المجال الذي يستطيع كل فرد أن يمارس فيه اختيارا عقلانيا فإن الفرد المستهلك لا يمكن أن تكون له في السوق سلطة ديمقراطية، وتحوّل المواطن إلى مستهلك يعني نهائيا التخلي عن الديمقراطية الاجتماعية وظهور نوع جديد من النظام يسميه بعض المفكرين بالديمقراطية الشعبوية للسوق، نظام تختزل فيه السيادة الشعبية في علاقة تاجر ومستهلك. وهذا الواقع الذي شخصه "توكيفيل" في ما سمّاه بالاستبداد الناعم والذي حلله "أدورنو" و"هوركايمر" جعل "ماركوز" ينتهي إلى رؤية تشاؤمية في نقده للمجتمع الاستهلاكي ذلك أن مجتمع السوق المحكوم بأوامر ماركانتيلية خاصة، اوامر اقتصاد السوق، لا يؤسس العدالة الاجتماعية، خاصة وأن هذه الأوامر ليس لها ما يحدّها أو ما يعارضها في الوقت الراهن عدى بعض حركات المقاومة الشعبية المعزولة والتي تأخذ شكل مظاهر عنيفة أو مرضية وحتى لا عقلانية في منظور العولمة مثلما بين ذلك "بودريار" الذي يبدو أكثر تفاؤلا من "ماركور" بما أنه، على الأقل، يعتبر أن العولمة لا تستطيع أن تعلن نصرها طالما هناك مقاومة.
غير أن الوضعية القانونية للمقامة تطرح مشكلا حقوقيا من وجهة نظر كانط، ذلك أنه "ليس ثمة أي مقاومة للشعب ضدّ الحاكم المشرع للدولة تكون مطابقة للحق"، فليس ثمة "حق عصيان" ولا "حق تمرّد". وكانط يذهب إلى أبعد من ذلك إذ يعتبر أن "أبسط محاولة في هذا الشأن هي خيانة عُظمى ومن يكون خائنا من هذا الجنس، باحثا على القضاء على وطنه لا يمكن أن يُعاقب بأقل من الموت". و في هذا الاقرار يبدو كانط وكأنه يتكلم على لسان أباطرة السوق، أولئك الذين ينعتون بالإرهاب كلّ محاولة للتصدّي لنجاحات اقتصاد السوق المعولم، وربما ما يبرّر هذا التحامل الكانطي على المقاومة، هو كون المشروع الكانطي يندرج في إطار بحثه عن تحقيق سلم دائم، وشأن كانط كفيلسوف هو أن يتحرّك وفق خلفية أخلاقية تجعله يرفض العنف في كلّ أشكاله حتى وإن كان مقاومة للطغيان، وكأن بكانط يسير على خطى "سقراط" عندما عرضوا عليه الفرار من السجن قبل إعدامه فرفض لأنه من واجبه احترام قوانين المدينة حتى وإن كانت جائرة. ولكن الفلسفة التي يمثل الاختلاف شأنها الملكي، جعلت ماركس يعتبر أن العنف الثوري الذي تمارسه الطبقة الكادحة هو عنف شرعي. فعندما يجعل الاستبداد بعنفه محلّ الحق والعدالة يجب مقاومته، فالاستبداد عنف ومقاومة هذا العنف لا تكون بالنسبة لماركس بالخطاب فحسب بل وأيضا بالقوة خاصة وأنها تبقى دينامية يمكن التحكم فيها في مقابل العنف الذي يمثل دينامية مجنونة.
ورغم إدانة كانط للمقامة، فإنه ليس لنا أن ننسى إضافته في مستوى دعوته للكونية، إذ مكننا كانط من الربط بين مستويات المواطنة، بين مواطن الدولة والمواطن العالمي بطريقة تسمحُ بالمصالحة بين الحق وكرامة الإنسان، بين هوية وسيادة الشعوب وتآزر كلّ متساكني الكوكب بما في ذلك اللاجئين السياسيين الذين حرموا من حق حماية دولة خاصة. ذلك أن المواطنة العالمية عند "كانط" تقتضي الاعتراف بالآخر كآخر، فالآخر في هذا المنظور الكانطي ليس غريبا بصفة مطلقة وليس هو نسخة مطابقة للذات، والعالمية التي ينادي بها "كانط" تصالح بين خصوصية الشعوب والغيرية، تصالح بين الهوية والاختلاف، تبرز الكوني في الخصوصي والخصوصي في الكوني. ذلك هو شرط الحوار الأصيل الذي يمكننا من تجاوز المفارقة التي أحالت إليها "حنّا أرانت" بين الحقوق الكونية والتجمّعات الخصوصية، حسبنا فقط أن ننتبه إلى الاستبداد الناعم الذي شخصه "توكيفيل" والذي هو بصدد بسط سلطانه بخطى حثيثة في الديمقراطيات المعاصرة. ولكن علينا أيضا أن نحترس من العولمة والفضاءات الجديدة التي أنتجتها لتفعل فيما بعد الحدود الجغرافية وما قد تمثله من خطر على السيادة وبالتالي على المواطنة التي لا تتحقق إلا في ظلّ الديمقراطية، فالمواطنة تتكون عبر الحوار وتبادل الأفكار وهو ما يقتضي تفكيرا مناسبا حول دور الاعلام في المدينة، خاصة وأن الاعلام اليوم يتموضع في مشهد السوق ولا يهتم أبدا بتبادل الأفكار وإنما يهتمّ بخطابات الأوغاد والحمقى مثلما عبر عن ذلك "ميشال هنري" في كتابه "البربرية"، ثم إن دكتاتورية وسائل الاتصال تمنع كلّ نقد باسم حرية الصحافة. ونخشى اليوم من أن تهيمن الديمقراطية الاتصالية وأن تهيمن وسائل الاعلام فتغيب الديمقراطية، لذلك يجب استغلال العولمة لنعلن الواجب الملح اليوم، واجب رفعه "كانط" منذ الحداثة يتمثل في بناء مواطنة عالمية تتأسّس على الثلاثية: حرية، مساواة، وإخاء، لأنه أن يكون الواحد منا مواطنا عالميا هو أن يعرف وأن يفهم وأن يشارك في حوارات المدينة الذي تمثلها اليوم "القرية العالمية" واللاّتجانس ليس حاجزا وإنما هو مثلما بيّن ذلك "إدغار موران" عامل محرّر : "إنه يجعل الامبراطوريات القديمة والحديثة تنهار ويفضل التجارب والوضعيات الجديدة".
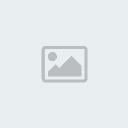
ريان-

- عدد المساهمات : 1804
العمر : 33
المكان : المظيلة
المهنه : المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة
الهوايه : الابحار على النت
نقاط تحت التجربة : 12443
تاريخ التسجيل : 27/02/2008
 رد: السيادة والمواطنة
رد: السيادة والمواطنة

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*الكلمة الطيبة كشجرة طيبة*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
... كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا * يرمى بصخر فيلقي أطيب الثمر ...
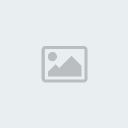

أنين الصمت-
- عدد المساهمات : 1248
العمر : 39
المكان : الجبال الصلدة
المهنه : بطالة مؤقتة
الهوايه : الصمت
نقاط تحت التجربة : 12341
تاريخ التسجيل : 26/12/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى




